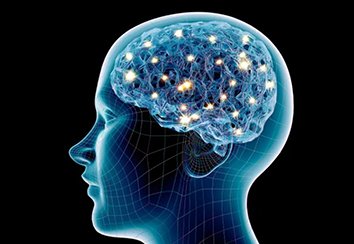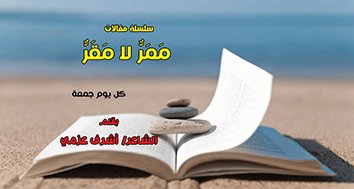في لحظة ما وأنت تتصفح كتابا قديما، قد تصادف سطرا بدا مألوفا… مألوفا إلى حد الغرابة، تجزم بأنك قرأته من قبل، لكنك تتفاجأ بأن الجملة تختلف عن تلك التي كنت تحفظها عن ظهر قلب، لا خطأ في الطباعة ولا تزوير في النص، كل ما في الأمر أن ذاكرتك—ومعها ذاكرة الكثيرين—كانت تذكّر شيئا لم يحدث قط؛ هنا تدخل منطقة غامضة تُعرف بـ “تأثير مانديلا”.
تأثير مانديلا ليس وهما فرديا ، بل تشوّه جماعي في الذاكرة؛ هو حين يتشارك عدد كبير من الناس تذكّر أمرٍ ما بطريقة خاطئة، رغم وجود أدلة واضحة تُكذّب ذلك التذكّر، وقد سُمّي بهذا الاسم بعد أن اعتقد الكثيرون أن نيلسون مانديلا توفي في السجن في الثمانينيات، بينما في الحقيقة توفي عام 2013، بعد أن أصبح رئيسا لجنوب أفريقيا.
لكن ما علاقة هذا بعالم الكتب والثقافة؟
في الثقافة والقراءة، يظهر تأثير مانديلا بأشكال دقيقة لكنها مقلقة، أحيانًا نتذكر اقتباسا شهيرا من رواية كلاسيكية، لكننا حين نعود للمصدر لا نجده كما حفظناه؛ نعتقد مثلًا أن دوستويفسكي قال: “إذا أردت أن تعرف إنسانًا، فانظر كيف يعامل من هم أضعف منه”، لكنها ليست جملة موثقة بالنص، كذلك يُنسب إلى شكسبير قول: “الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك”، وهي جملة عربية الأصل لا علاقة لها بالكاتب الإنجليزي.
تراكم هذه “الذاكرات المزيفة” لا يقتصر على الاقتباسات، بل يمتد أحيانا إلى مضمون الأعمال نفسها. كثيرون مثلا يعتقدون أن رواية “1984” لجورج أورويل كانت تتحدث عن المستقبل البعيد في عام 2084، بينما الرقم في العنوان لم يكن إلا عكسًا رمزيًا لسنة الكتابة: 1948.
جزء من هذه الظاهرة قد تعود جذوره إلى التعليم نفسه، حيث يُقدَّم الأدب والفكر في قوالب جاهزة، مقتطعة من سياقها؛ نُعلّم الطلاب مثلًا أن المتنبي قال: “أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي” وكأنها دليل على غروره فقط، دون التوقف عند معنى “الأدب” هنا كمفهوم حضاري شعري لا مجرد كِبر شخصي.
مع مرور الوقت، تتحول هذه “النصوص المشوهة” إلى حقائق راسخة في الوعي الجمعي، حتى إنك لو حاولت تصحيحها تُتهم بالخطأ، لا الذاكرة الجمعية.
إليكم أمثلة أدبية أخرى: يُعتقد أن شخصية “روبن هود” كانت سارقا نبيلا يعطي الفقراء ويقاوم الطغيان، لكن المرويات القديمة تُظهره أحيانًا كخارج عن القانون بلا بُعد أخلاقي واضح، كما أن كثير من الناس يربطون رواية “الشيخ والبحر” لهمنغواي بحكاية انتصار العجوز على الطبيعة، بينما الرواية في جوهرها تُجسد الهزيمة الوجودية المغلفة بالكرامة؛ حتى في القرآن الكريم، هناك من يعتقد خطأً أن “السماء تمطر نارًا” مذكورة حرفيا، أو أن عبارة “الوقت كالسيف” آية، وهي ليست كذلك.
القراءة لا تحصّننا دائمًا ضد هذه الانزلاقات، بل قد نكون ضحايا تراكمات معرفية مغلوطة زرعتها الكتب أو وسائل الإعلام أو حتى إعادة السرد. وهنا تكمن خطورة تأثير مانديلا: أنه يصنع ثقافة مزيفة، تبدو حقيقية أكثر من الحقيقة نفسها.
كيف نواجه ذلك؟
ليس الحل في الشك المرضي بكل ما نعرفه، بل في إعادة التحقق المستمرة والعودة إلى النصوص الأصلية وعدم الاكتفاء بما قيل لنا. القراءة ليست فقط تكديسًا للمعرفة، بل تدريب يومي على فن التذكّر السليم، والشك المعرفي الصحي.
في الختام، الثقافة الحية ليست تلك التي تحفظ، بل التي تُراجع وتُصحّح. ولعلّ أعظم ما يمكن أن تُعلمنا إياه القراءة، هو أن الذاكرة ليست مرآة، بل خيالٌ يُعيد تشكيل الماضي كما يشتهي… لا كما كان حقًا.
………………………..
👁️ عدد المشاهدات: 178